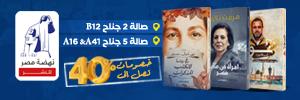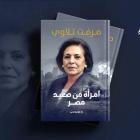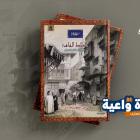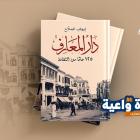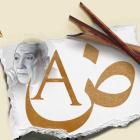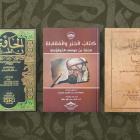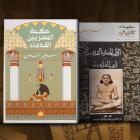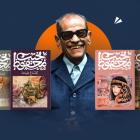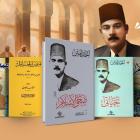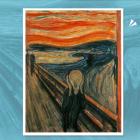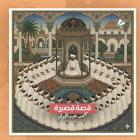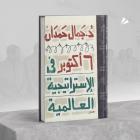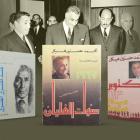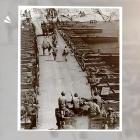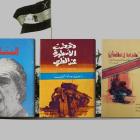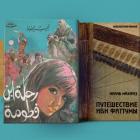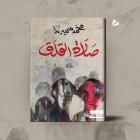معرفة
بين الرفض للتبعية والخضوع للاستبداد: كيف غيرت روسيا ثوبها؟
تغيّرت أنظمة روسيا مرات عدة، لكنها بقيت أسيرة معادلة واحدة: قوة سيادية تواجه العالم، وسلطوية تحكم الداخل. فهل يصمد النظام الذي بناه بوتين بعد رحيله؟
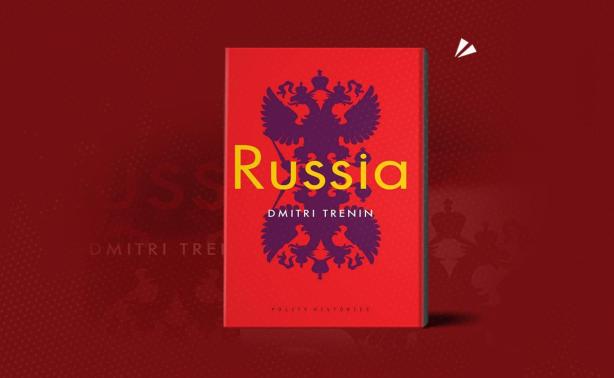 غلاف كتاب «Russia» لكبير الباحثين في مركز «كارنيغي» كان دميتري ترينين
غلاف كتاب «Russia» لكبير الباحثين في مركز «كارنيغي» كان دميتري ترينين
صدر الكتاب الذي بين أيدينا قبيل اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ومؤلفه أكاديمي روسي مشهور، عمل ضابطًا في الجيش السوفيتي وواكب التغيرات الكبرى التي مرت بها روسيا في مرحلة ما بعد غورباتشوف.
وفي الفترة شبه الليبرالية من حكم بوتين، التي سمحت فيها روسيا للغرب بإقامة بعض المعاهد ومراكز الأبحاث الغربية، وفي طليعتها مركز «كارنيغي»، كان دميتري ترينين – مؤلف كتابنا – كبير الباحثين في ذلك المركز، الذي سرعان ما أغلقته موسكو بعد شهرين من غزوها أوكرانيا.
تمثل كتابات دميتري ترينين موقعًا وسطًا بين الدعاية الروسية المنغلقة على نفسها، ذات الرؤية الذاتية الأيديولوجية المعادية للغرب من ناحية، وبين الكتابات الغربية المعادية لروسيا والساخرة منها. يقدم ترينين نقدًا لسياسات الدولة الروسية مع احترام عميق لهويتها وتاريخها، والكتاب الحالي نموذج مناسب لبعض أهم أعماله.
فلسفة التغير: 20 عامًا في مقابل 200 عام!
يفتتح المؤلف كتابه بالإشارة إلى حالة الاستهزاء الغربي بروسيا في الحقبة الشيوعية، باعتبارها دولةً ذات تاريخ غامض. ولا ينكر المؤلف غموض التاريخ الروسي، لا سيما فيما يتعلق بطريقة كتابة التاريخ في الدعاية السوفيتية الرسمية والكتب المدرسية؛ تلك الطريقة التي أُنكرت فيها حقائق مهمة عن رجال عظماء، بينما وُضع في دائرة الضوء آخرون لا مكانة لهم من العظمة، ليصبحوا في طليعة الدولة وصانعي قراراتها.
يقول ترينين إن روسيا ليست الوحيدة التي تسمح لقادتها بالتلاعب بالتاريخ لإضفاء الشرعية على حكمهم، أو المطالبة بمكانة خاصة في الشؤون العالمية، أو تحديد مسار مستقبلي. فهذا يعد جزءًا من سياسة التاريخ التي تمارسها عديد من البلدان، من أوروبا الشرقية ما بعد الشيوعية إلى أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، مرورًا بالقوقاز وآسيا الوسطى وما يشبهها من الدول الأخرى.
ويرى المؤلف أن روسيا اضطرت أكثر من مرة إلى إعادة اختراع نفسها. فكلما طرأت أزمة وجودية، انقلبت روسيا عمليًا على ماضيها، مما أدى إلى انقطاعات هائلة في مسارها التاريخي. وبناء على ذلك، تخلقت انقسامات واضحة تبدو غير قابلة للجبر والتجسير بين الفترات المفصلية الانتقالية التي تميز خمس مراحل كبرى في التاريخ:
-
روسيا الوثنية والمسيحية.
-
فترة ما قبل المغول في عهد إمارة كييف الأوروبية وتجميع الأراضي الروسية في موسكو تحت إمبراطورية القبيلة الذهبية الآسيوية.
-
القيصرية الموسكوفية الأرثوذكسية وإمبراطورية سانت بطرسبرغ ذات الهوى الغربي.
-
روسيا الإمبراطورية وروسيا السوفيتية.
-
روسيا السوفيتية وروسيا الاتحادية المعاصرة.
يذهب ترينين إلى أنه، رغم هذه التغيرات والفترات المفصلية، تعود بروسيا إلى نتيجة: اللاتغيّر! يبدو الأمر في ظاهره أن روسيا لا تتغير إلا كل قرنين من الزمن، بينما الحقيقة أنها تنقلب رأسًا على عقب في عشرين سنة، لكن بعد هذه السنوات العشرين تبقى روسيا غير متغيرة لنحو مئتي سنة!
يعني هذا وجود مرونة ملحوظة لبعض السمات الأساسية لوجود الأمة الروسية، وصورتها الذاتية، ورؤيتها للعالم. وكما يشبّه الفلاسفة روسيا، فإنها تبدو كطائر الفينيق: يتحول مرارًا وتكرارًا إلى رماد، ثم يُبعث من جديد. يكمن مفتاح فهم هذه التحولات في التجربة الجماعية للشعب الروسي.
ميلاد استثنائي لجغرافيا فريدة
يذهب ترينين في كتابه الحالي إلى أن روسيا شهدت على مدار تاريخها الممتد لألف عام، عددًا من التجسيدات. ظهرت روسيا لأول مرة في منتصف القرن التاسع كاتحادٍ لقبائل سلافية يحكمها الفايكنج، ويحكم هذا الاتحاد القبلي مساحة شاسعة من شرق أوروبا، من نوفغورود شمالًا إلى كييف جنوبًا.
عرفت هذه الوحدة الجغرافية في التاريخ باسم روسيا كييف (روسيا الكييفية، التي نشأت حول مدينة كييف)، وكانت نسخة شرقية من إمبراطورية شارلمان، وجزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي لأوروبا في العصور الوسطى، ومهدًا مشتركًا لروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا الحالية.
تزعم هذه الدول الثلاث – روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا – امتلاكها لهذا الإرث التاريخي بأكمله، لكن لا يمكن لأي منها أن يدّعي ملكيته الحصرية له. ويبقى أهم إنجاز دائم لتلك النسخة الأولى من روسيا الأوروبية المولد هو ظهور المسيحية الأرثوذكسية التي اعتنقتها روسيا من القسطنطينية عام 988.
دامت «روسيا كييف» لفترة أطول من مملكة شارلمان، لكنها هي الأخرى تفتتت في النهاية إلى مجموعة من الإمارات الإقطاعية التي تحكمها عائلة كبيرة واحدة من أمراء عدة. وبعد أن كانت كييف مركزًا مرغوبًا للحكم الروسي المركزي، فقدت أهميتها السياسية مع قيام المغول في أوائل القرن الثالث عشر بغزو واجتياح الأراضي الروسية.
تأسس الحكم المغولي في شمال شرق البلاد الروسية، وهو الإقليم الذي يشكل الآن نواة الاتحاد الروسي. أمضى الروس الذين عاشوا في تلك المنطقة 250 عامًا التالية ضمن الإمبراطورية الآسيوية الشاسعة التي أسسها جنكيز خان. وفي المقابل، تم دمج الإمارات الغربية (بيلاروسيا حاليََا) والجنوبية الغربية (أوكرانيا) في ليتوانيا والمجر، ولاحقًا بولندا.
يحلل ترينين التداعيات المترتبة على هذا الانقسام، ويرى أنها كانت حاسمة على هوية الشعب الروسي. لقد فقد الروس في شمال شرق البلاد تواصلهم مع الغرب، لكنهم حافظوا على عقيدتهم الأرثوذكسية. تعلم الروس من هذه التجربة القاسية دروسًا مهمة، أبرزها خطر الانقسام السياسي والتهديد الوجودي لعقيدة للمسيحية الأرثوذكسية.
في المقابل، شكّل الروس الغربيون والجنوبيون الغربيون (في أوكرانيا وبيلاروسيا) بعد سقوط الحكم المغولي أقليات أرثوذكسية داخل الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية في أوروبا الشرقية. ولم يتمكن هؤلاء من استعادة استقلالهم السياسي قط، لكن بعضهم اندمج في النظام الاجتماعي للكومنولث البولندي الليتواني.
أدى هذا الانقسام للأمة الروسية المبكرة إلى ثقافات ووجهات نظر سياسية مختلفة في روسيا من جهة، وأوكرانيا وبيلاروسيا من جهة أخرى.
أخطار الشرق والغرب: روح الشعب
نشأت موسكو بلدة متواضعة على نهر صغير، ثم تحولت إلى مدينة رائدة في نهضتها، ويرجع الفضل في ازدهارها إلى حدٍّ كبير إلى الأمراء الذين رسموا سياستها واقتصادها وصاغوا بمكر – لا يخلو من قسوة ووحشية – الصراع مع المنافسين. ويعاني موقع موسكو من انكشافه من كل حدب وصوب في السهل الأوروبي المكشوف، وهو ما عرض المدينة والإمارة لهجمات من كافة الجهات.
من الناحية الاستراتيجية، وقعت إمارة موسكو في خيار صعب في منتصف القرن الثالث عشر، حين وجد ألكسندر نيفسكي، أمير نوفغورود، أن بلاده تواجه المفاضلة بين خطرين:
-
خطر الحملات الصليبية القادمة من ناحية الألمان في الغرب.
-
خطر الحملات الآتية من الشرق بزعامة جحافل المغول.
على ألكسندر نيفسكي أن يختار بين الأمرين: أن يصبح تابعًا خاضعًا للصليبيين الألمان، أو للوثنيين المغول. وكانت المفاجأة أن اختار نيفسكي أن يدفع الجزية للمغول ويخضع لسيادتهم تفضيلًا لهم على المسيحيين الصليبيين الألمان.
وفي مبرره لذلك، كان يؤسس لمبدأ روسي مهم، وهو أن البلاد قد تفقد جسدها للأغراب، وهذا أقل خطرًا من أن تفقد روحها الأرثوذكسية لصالح التحول إلى الكاثوليكية، لأنه لو حدث ذلك لفقدت روسيا روح الشعب.
ومن ثم، أصبحت الكنيسة الأرثوذكسية – منذ القرن الرابع عشر – المرشد الروحي للنهضة الوطنية في شمال شرق روسيا. وعندها نجح أمراء موسكو في جعل مدينتهم مقرًا لمطران عموم روسيا، الذي كان مقره سابقًا في كييف.
يقول ترينين إنه منذ ذلك الحين، أصبحت الوحدة السياسية والروحية – التي تعكس التناغم البيزنطي بين الإمبراطور والبطريرك – والخيار الجيوسياسي لألكسندر نيفسكي، من السمات الرئيسية لـ «الروح الروسية».
إعادة اختراع روسيا
بحلول أواخر القرن الخامس عشر، أعاد حكام موسكو اختراع روسيا في مرحلة جديدة. فلقد نجح أمير موسكو الكبير إيفان الثالث في تأسيس أول دولة روسية موحدة. لم يكتفِ إيفان الثالث بإعادة تجميع إمارات الشمال الشرقي المتفرقة تحت دولة مركزية، بل أطاح أيضًا بـ «نير المغول».
في انقلاب تاريخي، سرعان ما سيطر حكام موسكو على الخانيات المغولية، ومعظمها تركية الأصل عرقيًا، وكانت تابعة للقبيلة الذهبية، فضمّوها بالقوة إلى الدولة الروسية الجديدة.
أصبح هذا التكامل لاحقًا نهج الإمبراطورية الروسية. كما تبنّى الروس ثقافة سياسية استبدادية جعلت دولتهم قوية وشعبهم خاضعًا لها.
ولم يكن هذا كل شيء، فبعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية في أيدي الأتراك العثمانيين في منتصف القرن الخامس عشر، ادعت موسكو الزعامة الروحية للعالم الأرثوذكسي بأكمله، باعتبارها روما الثالثة.
وروما الثالثة مصطلح يعني أن موسكو جاءت بعد سقوط روما الأولى، وسقوط القسطنطينية (روما الثانية). والطريف أن الأمراء الروس قالوا إنه لن تكون هناك روما رابعة.
وانطلاقًا من نفس سلالة أمراء كييف القدامى، ادعى أمراء موسكو العظام أحقيتهم في جميع أراضي روسيا كييف السابقة.
ورمزيًا، اعتمدت روسيا النسر البيزنطي ذي الرأسين شعارًا. وفي منتصف القرن السادس عشر، رقّى أمير موسكو إيفان الرابع نفسه إلى قيصر، وبعد بضعة عقود أصبح مطارنة موسكو وجميع روسيا بطاركة للقيصرية.
وهكذا، وضع قياصرة وبطاركة روسيا أنفسهم على قدم المساواة مع أباطرة الرومان المقدسين وبطاركة القسطنطينية.
شهدت هذه الدولة، التي ستعرف باسم «روسيا الموسكوفية»، فترة عصيبة في أوائل القرن السابع عشر، نتجت عن نهاية السلالة التي أسست روسيا كييف، وصدّت محاولة من بولندا المجاورة للاستيلاء عليها، وأسست سلالة جديدة هي سلالة رومانوف، وضمت شرق أوكرانيا إلى المملكة، وشهدت انقسامًا دينيًا صادمًا داخل الكنيسة الأرثوذكسية.
بطرس الأكبر وميراثه
يقول ترينين إنه، رغم هذا الكفاح، ظلت روسيا متأخرة من نواحٍ عديدة عن جيرانها في أوروبا حتى ظهر ملكها المجدد الطموح في عام 1700: القيصر بطرس الأكبر.
سعى بطرس الأكبر إلى الوصول المباشر إلى بحر البلطيق ليتمكن من التجارة مع الدول المتقدمة في أوروبا الغربية. ولتحقيق ذلك، شنّ بطرس حربًا على السويد التي كانت تسيطر على شواطئ البلطيق. وقد منحت هذه الحرب الطويلة روسيا بنية دولة حديثة، وحولتها إلى قوة أوروبية عظمى، عاصمتها سانت بطرسبرغ، وهي مدينة بُنيت من الصفر وسط مستنقعات البلطيق. وأصبح التغريب جوهر سياسة الحكومة.
دامت الإمبراطورية الروسية قرابة مئتي عام، وتوسعت لتشمل مساحة واسعة من الأراضي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأقصى. وفي مطلع القرن التاسع عشر أحبطت غزو نابليون، وصارت عنصرًا لا غنى عنه في اتفاقية أوروبا وتوازن القوى العالمي. بدأت في التحديث في وقت متأخر، لا سيما بعد إلغاء العبودية عام 1861، لكن بحلول أوائل القرن العشرين كانت تتطور بوتيرة سريعة.
روسيا المتناقضة
يرى دميتري ترينين أنه، حتى طيلة مئتي سنة منذ تجربة بطرس الأكبر، أنتجت روسيا سلسلة طويلة من الكتّاب والشعراء والملحنين وراقصي الباليه من الطراز العالمي. ومع ذلك، خنق نظامها السياسي المحافظ بشدة الحرية، وولّد بعضًا من أكثر عناصر المعارضة تطرفًا، من الإرهابيين العدميين إلى البلاشفة.
وكان المركز السياسي ضعيفًا للغاية، وكان فقدان القيادة العليا للسيطرة بمثابة كارثة. نيقولا الثاني، آخر إمبراطور لروسيا، كان رجل عائلة عريقة، لكنه فشل فشلًا ذريعًا كقائد. وكانت النتيجة ثورة 1917 التي قضت على النظام والدولة والبلاد تمامًا، وسرعان ما وُلدت دولة جديدة: الاتحاد السوفيتي، الذي اعتبر النظام القيصري عدوًا طبقيًا.
لم يكن الاتحاد السوفيتي محكومًا عليه بالسقوط حين سقط، ومع ذلك – وكما حدث مع نيقولا الثاني – فإن فقدان ميخائيل غورباتشوف السيطرة كان له أثره المدمر. ومع ذلك، وبعد ثلاثة عقود من تفكك الاتحاد السوفيتي، لا يبدو الاتحاد الروسي وقد تبنى قطيعة تامة مع الماضي، بقدر ما يبدو استمرارًا للاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية وقيصرية موسكو. وما زال الشعب الروسي يسأل نفس الأسئلة: «من نحن؟» و«إلى أي جغرافية حضارية ننتمي؟»
تبدو روسيا سلسلة متعاقبة من الدول، تغيّر ثوبها بشكل دوري، لكنها في كل مرة تحتفظ ببعض السمات الرئيسية. ومن أهم هذه السمات تلك الثنائية المتناقضة التي تجمع بين:
-
رفضٌ قاطع لأي شكل من أشكال التبعية للقوى الخارجية.
-
رضوخٌ متزامن للحكم الاستبدادي القاسي في الداخل.
بعبارة أخرى، يفخر الشعب الروسي بحرية دولته السيادية على الساحة الدولية، بينما هو مستعد للتنازل عن سيادته الداخلية في مواجهة تلك الدولة نفسها.
ويخلص ترينين إلى أن «الدولة»، التي تُسند السلطة إلى رئيسها الاسمي، هي التي هيمنت على الأمة الروسية. أي أنه ليس الحكام وحدهم، بل حتى معظم الناس العاديين يعتبرون الدولة القيمة الوطنية العليا. يرى ترينين أن الدولة المشتركة – وليس العرق أو الدين – هي التي توحّد الشعب الروسي. ومرد ذلك واضح ومفهوم ويمكن صياغته في عبارة تختزل فلسفة التاريخ:
«إن انهيار الدولة الروسية، الذي حدث ثلاث مرات خلال الأربعمئة سنة الماضية، يطلق شرورًا تُعتبر أسوأ من الاستبداد السلطوي الداخلي».
ومن هنا، تستمر روسيا في تناقضها بين الرفض القاطع لأي تبعية خارجية، والرضوخ المتزامن للحكم الاستبدادي في الداخل.
خطة الكتاب وفصوله
يغطي كل فصل من الفصول الستة التالية في المتوسط عشرين عامًا من التاريخ.
- يتناول الفصل الأول، الذي يمتد من عام 1900 إلى عام 1920، الاضطرابات الثورية في أوائل القرن العشرين وتداعياتها، ويصف اقتصادًا نابضًا بالحياة، ومجتمعًا غير مستقر، واستبدادًا ثابتًا، وكنيسة أرثوذكسية تُديرها الدولة وتزداد بعدًا عن المجتمع. ويتناول أول معركة لروسيا في القرن العشرين التي خسرت فيها أمام اليابان، وينتقل من ثم إلى الثورة الروسية الأولى ثم الحرب العالمية الأولى، التي كانت المحفز الرئيس للتغيير العنيف القادم، ويسعى الفصل إلى فهم التطورات الثورية لعامة 1917، من سقوط سلالة رومانوف في فبراير إلى استيلاء البلاشفة على السلطة في أكتوبر.
-
يتناول الفصل الثاني (1921-1938) صعود الاشتراكية السوفيتية كنظام شمولي بخصائصها السياسية والاقتصادية والاجتماعية البارزة، ويتناول تحديدََا التوحيد السياسي تحت حزب واحد متجانس وبيروقراطيته، والتصنيع الاقتصادي، والتجميع الزراعي (الذي كان في الواقع حربًا على الفلاحين)، والإلحاد الرسمي والحرب على الدين، إضافة إلى القمع الجماعي ومعسكرات العمل القسري (الجولاج).
-
يتعرض الفصل الثالث (1939-1952) للفترة التي سبقت الحرب الوطنية العظمى (الاسم الروسي للحرب العالمية الثانية)، ثم الحرب نفسها، وإعادة الإعمار بعد الحرب. ويولي اهتمامًا خاصًا للسياسة الخارجية والدبلوماسية لموسكو ومواصلتها الحرب. ويتناول سلوك الشعب السوفيتي في فترة المحنة حتى انتصاره، وفي تناوله لفترة ما بعد الحرب، يعرج الفصل على جذور الحرب الباردة من منظور روسي، كما يغطي السنوات الأخيرة من حكم ستالين.
-
يولي المؤلف في الفصل الرابع عنايته للنظام السوفيتي من خلال تحليل أهم ثلاثة عقود – من عام 1953 إلى عام 1984 – التي تعتبر خير تمثيل للاتحاد السوفيتي كما لا تزال الأجيال الحية تتذكره.
-
أمّا الفصل الخامس فيدرس فترة الاضطرابات الجديدة – من عام 1985 إلى عام 1999 – مع تحليل سياسات البيريسترويكا والغلاسنوست وما بعدهما، من صعود يلتسين وانسحابه حتى ظهور فلاديمير بوتين.
-
الفصل السادس والأخير يبدأ في الأول من يناير 2000، وهو أول يوم كامل من رئاسة فلاديمير بوتين. يرى المؤلف أن بوتين أعاد النظام، وزرع في النفوس الاعتقاد بأن الدولة الروسية قد عادت، ونجح في الحفاظ على البلاد سليمة دون انتقاص جغرافي، وهي تتمتع بنفوذ قوة عظمى – مرة أخرى – وإن كان ذلك على حساب مواجهة مع الولايات المتحدة.
أصبح بوتين الأب الروحي للرأسمالية الروسية المعاصرة، بشركات الدولة، وأباطرة المال المروضين، وعدم المساواة الصارخ. ومع ذلك، فهو أيضًا شخصية انتقالية، ومن المرجّح ألّا يصمد النظام الذي بناه بعد رحيله.